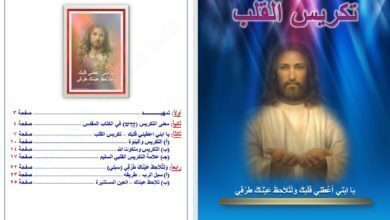الإرشاد الأُسري
ثورة ميلاد – مشكلة تعامل الأهل مع الأبناء – مرحلة المراهقة وبدء مرحلة النضوج والشباب

ثـــــــــــــــــــــــورة ميلاد
يقول الدكتور يوسف إدريس “في جريدة الأهرام (3/7/1977): [ يُخيل أننا في بلادنا العربية أكثر الشعوب جهلاً في مواجهة هذه الثورة.. ثورة الشباب، لم نُدرك أنها ليست مسألة هينة.. نُسميها مشاكل المراهقة، وما هيَّ بمشاكل، وما هيَّ بمراهقة، إنما هي ثورة ميلاد.
وكي يتم التعامل مع “ثورة الميلاد” فلا بُدَّ من تفهم طبيعة هذا المولود الثائر الهائج، وتفهُم ما يمرَّ به. وإذا ما تم ذلك، فسوف تكون خطوات التعامل واضحة، نخطوها بقدمين راسختين ]
يشكو الغالبية العظمى من الشباب من أن آبائهم لم يعودوا يفهمونهم، كما كانوا يفعلونه معهم من قبل في مرحلة الطفولة ( وطبعاً احتمال كبير والمصيبة الكبرى أنه يكون الأهل أساساً ليس لديهم أي لغة تفاهم مع ابنهم منذ الصغر) ويلاحظون وجود “هُوّة سحيقة” تزداد اتساعاً وعمقاً بين فهمهم هم للأمور [1] (وبخاصة شئون حياتهم الشخصية، وتصرفاتهم فيها) وفهم الآباء وتصرفاتهم تجاه حياتهم الشخصية.
وطبعاً هناك سؤال دائماً يطرحه الآباء في هذه الأيام:
س: ألسنا في حاجة شديدة إلى من يُحدثنا عن الأساليب السليمة التي تساعدنا على القيام بمهمتنا التربوية لأولادنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ونجيب على ذلك بقولنا:
أن التربية العائلية أكثر بكثير جداً من مجرد أساليب أو واجب مفروض على الآباء والأمهات!! بل أنها في الأساس موقف شخصي في أعماق الوالِدين تجاه أولادهم (من بداية طفولتهم)، وهذا الموقف هو تحديد نوعية العلاقة بينهم وبين أبنائهم وأسلوب تصرفهم تجاههم.
فإذا كان هذا الموقف سليماً كان للتربية حظ كبير أن تكون ناجحة مع اختلاف التعامل وتعدد الأساليب من سن لآخر ومن مرحلة لأخرى، وعلى قدر ما يكون موقفنا سليم وقوي على قدر ما تفقد أخطائنا التربوية – التي أحيان ما نرتكبها كثيراً جداً دون قصد – الكثير من أهميتها.
على العموم نتساءل قائلين: أي والد أو والدة لا يحبون أبنائهم!! طبعاً الكل سوف يقول أن جميعنا بلا أدنى شك نحب أولادنا ونضحي من أجلهم، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يُنكره أبداً لأنه حقيقي فعلاً، ولكن ممكن أن نضيف قائلين:
لا يكفي أبداً أن نحب؛ ولا يكفي على الإطلاق أن نضحي؟
بل ينبغي أن نتساءل كيف نحب وكيف نضحي ولماذا نضحي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبمعنى أدق ينبغي أن نتساءل عن نوعية حبنا وطبيعته ؟؟؟
فهناك حب يُحي وحب يُميت، وحب يُحرر ويُطلق وحب يُكبّل ويخنق!!!!!!
فما هوًّ نوع حبنا يا ترى؟؟؟
كلنا، بلا شك، نود أن نحب أولادنا الحب الصحيح، الحب الذي يُنميهم ويُحررهم من كل قيد نفسي أو عقلي، الحب الذي يسعدهم.
لكن علم النفس يؤكد أن عندنا دوافع لا شعورية في أعماقنا في الداخل، فهناك رواسب في داخلنا منذ طفولتنا وهيَّ متأصلة فينا، وذلك بسبب التربية التي نشأنا عليها، والظروف التي مررنا بها، والبيئة التي عشنا فيها والدراسة التي تلقيناها… الخ..، كل هذا يؤثر في شخصيتنا و يختلط بحبنا لأولادنا، وذلك كفيل بأن يجعل علاقتنا بأبنائنا تنحرف عن مجراها السليم وتؤثر في شخصية أولادنا.
ومن جهة أخرى نعلم أن أولادنا عبارة عن مجموعة تناقضات تحيرنا بل وتربكنا أحياناً وخاصة إذا بلغوا مرحلة المراهقة، ولكن الحق يُقال أننا أيضاً لا نخلو من هذا التناقض الذي نشكو منه عند أولادنا. وقد نعي أحياناً – قليلة جداً للأسف – بعض مظاهره:
فمن منا لم يرى أنه تارة يودّ لو يهب أولاده أغلى ما لديه بل حياته نفسها، وطوراً يضيق بهم ويتضايق جداً لأقل إزعاج منهم أو لأية هفوة يرتكبونها؟ وتارة يعطيهم بسخاء ولهفة وقته وجهده وكل ما يمتلكه، وأحياناً أخرى يأنبهم على ما صنعه لأجلهم وكيف ضحى بكل غالي وثمين لأجلهم؟ وأحياناً يعتبرهم قرة عينه، ومركز حبه، وأحياناً عبئاً عليه وثقل لا يستطيع احتماله؟
أحياناً يستقبل أفعالهم الطائشة وأخطائهم بالصبر والتأني وأحياناً، يُحاسبهم بلا رحمة بالضرب والإهانة [2]، والصياح المبالغ فيه لدرجة الصراخ بغضب يفوق الطوفان أحياناً، ولا يدري الأب أو الأم أنهم يسببون مشكلة نفسية لأولادهم لا يقدر أعظم أطباء علم النفس على حلها بسهولة أو قد لا تُحل أبداً. عموماً لابُدَّ من أن ننتبه لهذا التناقض فينا ونلاحظ أنفسنا دائماً وننتبه لخطواتنا التي نخطوها.
وعموماً هناك اتجاهين في التربية: الاتجاه الأول هوَّ اعتبار الولد وسيله، والثاني هو اعتبار الولد غاية.
أولاً: اعتبار الولد وسيلة:
نحن كثيراً بلا وعي أو شعور نجرد أبنائنا من شخصيتهم، ونحولهم لشيء ندّعي امتلاكه. وكثيراً ما نرى أبناء تأذوا من حب آبائهم وتفانيهم لدرجة إن والديهم يخططون ويرسمون حياتهم بدقة ويستمروا في النصح وإملاء آرائهم على أولادهم للتنفيذ وليس مجرد رأي بل أجبار على التنفيذ ( مثل المأكل والملبس والمدرسة والأصدقاء وطريقة المذاكرة وتنظيم الوقت وإجبارهم أن يجلسوا في الوقت الذي يحدده الوادلين بدون حرية …الخ)، وان لم يستجيب الولد لرأي الأهل وتنفيذ ما يملون عليه فأن العقاب في أشد صوره هوَّ ما ينتظره ولا يوجد بديل عنه، لأن الوالدين دائماً على صواب ويعرفون تماماً مصلحة الأولاد، ولا يُعطوا للولد فرصة أبداً أن ينمو وفق طبيعته كشخصية مستقلة لهُ رأيه في حياته وله الحق أن يرسم مستقبله في كل مرحله حسب سنه بتوجيه والديه وليس بإجبار والديه، اللذان دائماً لا يضعا لآراء أبنائهم أي اعتبار أو اهتمام، وكأن ليس لرأيهم أي قيمة لأنهم صغار لا يستطيعوا أن يستوعبوا أو يدركوا مصلحتهم، فنحن الأفضل دائماً، بل وعلى الإطلاق، في الاختيار وإبداء الرأي…
فكثيراً جداً لا ننتبه إلى أنانيتنا المستترة، لأننا نجد أفضل المبررات ونعتقد حسن النية في أنفسنا، ونثق في حكمتنا بحكم أننا الكبار والأهل ولنا الخبرة بسبب أننا أدرى بأمور الحياة، ولنا القدرة على التمييز ومعرفة الأشياء، وأننا نعمل لصالح أولادنا وخيرهم وبنائهم بناء سليم، أما هم فليسوا على مستوى الحكمة أو المعرفة المطلوبة، أو المسئولية لأنهم صغار لا يفهمون أو يدركون…الخ.
ولهذا الموقف مظاهر متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- اتخاذ الولد فرصة لإشعار الأهل بأنهم مهمون وضروريين، لأن شعورنا بوجود أحد في حاجة إلينا يجعلنا نشعر بأهميتنا ويُشبع ويُرضي نفوسنا وهذا ليس بعيب، ولكن العيب والخطورة هوَّ إذا زاد عن الحد المطلوب، فبدلاً من مساعدة الطفل على تجاوز هذه المرحلة أي مرحلة مساعدة الأهل، والاعتماد عليهم، ينزلق الأهل إلى استغلال تبعية الولد لأهله لتأكيد ذاتهم وان الولد لا يستطيع أن يستغنى عن آرائهم وأفكارهم وتوجيهاتهم… الخ، فهناك شعور دفين في أعماق الوالدين بأن أبنائهم كلما نموا وازدادت طاقتهم على تدبير أمورهم بأنفسهم، وقوى شعورهم باستقلالهم الشخصي، يفلتوا من أيديهم، وينتابهم جزع نابع من أحساس بفقدان أهميتهما. والخطورة تكمن هنا في توقف الطفل عن نموه النفسي وقدرته على التصرف تجاه المجتمع، بمعنى آخر شخصيه ضعيفة لا تقوى على المواجهة؛ فيبقى حتى بلوغه المراهقة طفلاً بعاطفته تابعاً للوالدين لا يجرؤ على القيام بأية مبادرة من تلقاء ذاته ولا يستطيع أن يتطلع خارج الأسرة أو يصنع علاقات خارج نطاق الأسرة، وحتى أن حاول أن يصنع علاقة مع الآخرين تكون علاقة متوترة يشوبها الكثير من النقص والضعف والخلافات وتُهدم بسهولة جداً، وللأسف الشديد أن الأهل يُسرّون بوضع كهذا ويتباهون بأن ولدهم “عاقل” وقد نجحوا في تربيته تربيه عائليه سليمة 100% معتبرين تبعيته “طاعة” وخجله “تأدباً” وبلادته “هدوءاً”، غير مدركين أنهم فشلوا في مهمتهم التربوية فشل زريع، لأنهم جعلوا من ابنهم كائناً لم تُكتمل إنسانيته غير قادر على شق طريقه في عالم الراشدين وعلى مواجهة صعاب الحياة، وقد يتأخر هذا الولد في دروسه وذلك بسبب أنه ينتقم بصورة غير واعية من والديه الذين سلباه حقه في استقلاله الشخصي وإعطائه الفرصة في التحكم في مستقبله، وبذلك يُقلق والديه ويذلهم بعجزه وتقصيره بتخلفه المدرسي.
ملحوظة : لا بد لنا أن ننتبه أن الحماية المفرطة لأولادنا، وإن كانت تتخذ لنفسها شتى المبررات، إنما تُرضي عادة رغبة خفية لدى الوالدين بامتلاك أبنائهم، فتُصيب الأولاد بضرر بالغ إذ تجعلهم ليس لديهم ثقة في أنفسهم وتجعلهم دائماً يتكلوا على الوالدين أو أي شخص آخر في حكم الوالدين، وعند البلوغ يجعلوا دائماً كل من هو أكبر في السن أو في الحالة الاجتماعية (كمدير أو ناظر أو مهندس ، أي شخص أعلى) جدير بالاتكال عليه، والمصيبة أيضاً عند الزواج، وهيَّ الرغبة في زواج من هوَّ أكبر في السن [3]، أو المستوى الاجتماعي… الخ
2- اتخاذ الولد واسطة لممارسة السطوة على الأضعف، وهنا دائما ما نظهر لأولادنا أننا نعرف كل شيء ولدينا دائماً إجابة على كل سؤال ونحن مُلمين بجميع أمور الحياة ولا نخطأ في معرفة ولا في حكم أو أمر وبخاصة في حياتهم الشخصية ومستقبلهم، لذلك دائماً نتمسك بشراسة وإصرار بتنفيذ إرادتنا مهما كان الثمن كما لو كانت إرادة معصومة من الخطأ ونسينا أننا بشر ممكن أن نخطأ، مهما كنا حكماء وملمين بجميع أمور الحياة (وطبعاً من المستحيل أن ندرك جميع الأمور لأننا في عالم متغير كل يوم وفي كل جيل)، وكأن القضية ليست قضية توعيه أبنائنا إلى ما فيه خيرهم وسلامهم، وتوجيه إرادتهم وما يلائم مصلحتهم الحقيقية ويساعدهم على تحقيق كل إنسانيتهم. إنما صارت القضية قضية صراع لا بُدَّ من أن يخرج منه الوالدين منتصرين ولو لم يكونوا على حق، مبررين سطوتهم بشتى الطرق وبحجة التربية السليمة والمنطق والعقل، معتبرين كل الأساليب مشروعة في سبيل تحقيقها، من ضرب موجع إلى تحقير الولد وإذلاله ومحاولة أقناعة أنه لا يفهم شيئاً ولا ينفع شيئاً، وبوصفه بالمخرب أو بالغبي وبقول الأب أو الأم حينما يغتاظ من ولده فيصرخ فيه قائلاً: [ أنت غبي أو أنتِ غبية، أو أنت عديم التركي، أو أنت مش نافع، أو أنت خرابه (أي يفسد كل شيء يمسكه بيده أو يلعب بيه…الخ)، صديقك فلان أو أخوك أحسن منك، صديقك أو أخوك أو أختك بتركز وأنت لأ،يحافظوا على حاجتهم وأنت لأ… الخ ]، وهكذا سلسلة لا تنتهي من الألفاظ المؤلمة للطفل، والتي سترافق مسيرة حياته كلها وتسبب له ألم نفسي قاسي لا يستطيع محوه ولا أعظم أطباء العالم في الطب النفسي، فما هيَّ نتيجة موقف كهذا يا ترى:
الخطر الكبير في أنه يقود لاحتمالين. الاحتمال الأول: إما أن تتحطم شخصية الولد ويصبح العمر كله يخاف من الحياة، غير واثق في نفسه، تنقصه الشجاعة والإقدام، لا يجرؤ على تأكيد ذاته بشكل طبيعي في العلاقات الاجتماعية واحتلال مكانه المشروع بين الناس لأنه لم يُعطيه والديه الفرصة بأن يؤكد ذاته عندهم، مما يقوده للفشل في كل ما يحاول تحقيقه؛ والاحتمال الثاني هوَّ ردّ فعلي ثأري عنيف يختبئ وراء احترام ظاهري للأهل ( في حين أنه قد يُنفس عنه بأعمال قسوة تُرتكب بحق الرفاق أو الأخوة والأخوات والزملاء أو الحيوانات وبخاصة الأليفة منها ) إلى أن تنفجر في المراهقة، وتصير قوة مدمرة قد تشمل لا الأهل [4] فقط إنما كل سلطة بشرية بل وحتى إلهيه!!
3- اتخاذ الولد وسيلة لتحقيق ما كان الأهل يرغبونه لأنفسهم: أحياناً نجد أنفسنا فشلنا في أن نحقق أحلامنا وأمانينا التي كنا نتمناها، ونحاول أن نحقق أحلامنا الخاصة عن طريق أولدنا ونجاحهم، وذلك جيد جداً ومشروع أن يهتم الأب وتهتم الأم ويسعوا معاً ليجدوا لأولادهم نصيباً أفضل من الذي نالوه هم في حياتهم، وأن ينال أولادهم ما حُرموا منه هم شخصياً، ذلك مطلوب بشرط: [ أن نحترم طريقه أولادنا الخاصة إلى النجاح والسعادة، فأولادنا لم يوجدوا أصلاً لتحقيق رغباتنا وأحلامنا الخاصة والذاتية، أياً كان جمالها وسموّها، بل لينموا وفقاً لإمكانيتهم ومواهبهم وميولهم الخاص ].
وتقول أحدى الأخصائيات النفسية: ( ليس بالأمر السهل….. على الأب والأم أن يقبلوا بأن أولادهم مختلفين عنهم، وبأنهم، رغم كثير من وجوه الشبه بينهم وبين والديهم، ليس لهم نفس الشكل الجسدي، ونفس المواهب، وليس متحمسين لنفس المواضيع والأهداف: فأبنتنا أو ولدنا شخص آخر لا بُدَّ وان يبتعد مستقبله، بدرجات متفاوتة، عن الحلم الذي كوّناه عنه)، لذلك فقد تكون أحلامنا عبئاً ثقيلاً على أولادنا لأن أحلامنا لا تنسجم مع طاقتهم الشخصية أو رغبتهم الخاصة، أو قد تكون مختلفة عن ظروف المجتمع الجديد الذي يعيش فيه. فأحياناً كثيرة نتعامى – عن قصد أو غير قصد – عن وضع أبنائنا فننظر إليهم من خلال رغباتنا وأحلامنا الشخصية فمثلاً: [ يكون لنا ابن متفوق في الذكاء وله قدرة كبيرة على التحصيل ولأننا كنا نحلم في صغرنا أن نكون في الطب أو الهندسة فندفع ولدنا دفعاً بالضغط واللين وبكل وسيلة ممكنه حتى نحقق فيه ومن خلاله ما كنا نتمناه ولكن الظروف لم تسمح لنا أن نحقق ما تمنيناه، غير مُقيمين وزناً لما لأولادنا من خصوصية ورغبات وأحلام خاصة ظاهره في ميولهم وتمنياتهم (التي لم نهتم يوماً أن نعرفها ولو عرفناها ننساها ولا نضعها في اعتبارنا على أساس أنها أحلام طفولة بريئة ليس لها قيمة ولن تتحقق)، والنتيجة – للأسف – تأتي عكس ما نتمناه فقد يحدث لأولادنا أن يُصابوا بالفشل في الدراسة بل وربما يُصابوا بحالات من الإحباط والإكتئاب.
يقول الدكتور هربرت شافّر: [ منذ نعومة أظفاره، يجد الولد نفسه مرهقاً بأعباء متطلبات وتوقعات لا تتناسب مع ميوله الذاتية بل مع آمال والديه الفائقة التوتر. إن هذا العبء المرهق يسبب تثبيطاً عميقاً لهمته. في بداية الأمر يتوصل إلى أرضاء توقعات أهله المفرطة عَبر تضحيته بكل نشاط آخر، من باب اللعب أو الرياضة (أو الدراسة …الخ)، ولكن، عند أول فشل، يحصل الانهيار، فإذا (بالوالدة أو) الوالد، وقد جرحته شخصياً هزيمة الولد، فيوبخ ويُعاقب. ومنذ ذلك الحين يتدهور الوضع بسرعة. فالولد لا يحرز أي نجاح ويخمد اهتمامه بالدراسة ]، فلنحذر تمام الحذر، من أن نكون سبب فشل لأولادنا بحجة أننا نراعي مصالحهم ونريد لهم الأفضل، فتصبح النتيجة أسوأ مما نتوقع فينهار كل شيء.
وربما نجد النقيض في أن بعض الآباء يريدون تحقيق أحلامهم الضائعة من الحرمان من خلال أولادهم، فصمموا على ألا يحرموا ولدهم من أي أمرّ يرغب فيه. وان يتركونه يأخذ كل ما يُريد، ويحققوا جميع رغباته ومطالبه مهما ان كانت ولو على حساب نفسه أو على حساب الأسرة من مال أو مجهود أو أي شيء آخر، ويدللون ولدهم بشكل مفرط ويمتنعون عن وضع أي حدّ لرغباته، وقد يتحججون بأنهم لا يريدون أن “يعقدوا” ولدهم أو أن يحرموه كما حدث لهم في الصغر. وطبعاً يعتقد الأهل بأنهم بذلك يعبروا عن حبهم الحقيقي بل والكبير لأبنائهم، غير عالمين إنهم يجعلونهم – دون قصد – أنانيين وفي حالة قلق داخلي وعدم استقرار، معقدين غير مكترثين حتى لوالديهم عند البلوغ، والنتيجة ان تثور الغرائز عند أولادهم بشكل غير طبيعي وتقودهم للانحراف، ويعيشوا في حالة من القلق والاضطراب الدائم وحالة من الضياع والتيه وفقدان معنى الحياة، والرغبة في امتلاك الأشياء والغيرة من الآخرين، حتى الأخوة والأخوات والأسرة، وحب الذات واستحواذ كل شيء في حالة من الأنانية المفرطة.
عموما وباختصار نجد أن هناك فجوة عظيمة بين الأهل والأبناء وخاصة في سن المراهقة، وهناك حتماً أسباب لهذه الفجوة: هناك سببان كامنان وراء هذه الفجوة:
أولاً: اختلاف مفاهيم الآباء عن مفاهيم الأبناء، وهذا طبيعي لاختلاف الأجيال والأزمان، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار سرعة تغير مجتمعاتنا (لاننسى أن الأبناء يعيشون الآن في عالم المتغيرات السريعة، وعالم أكثر انفتاحية: فضائيات، إنترنت،كمبيوتر…، بينما عاش جيل الآباء خبرة التلفاز – أبيض وأسود – عندما كانوا في مثل سنهم، أو إنهم كانوا في بداية حركة التكنولوجيا)
ثانيًا: اختلاف البيئة، بين البيئة التي نشأ فيها الأهل وتكوّنت شخصيتهم وبيئة الأولاد، وأيضاً اختلاف الدراسة والمدارس والتربية، وكم هائل من التغيرات حتى في أسلوب التعامل والأصدقاء، ولذا نرى أن “صراع الأجيال” ستزداد حدته يوماً بعد يوم لأن العالم سيستمر في التغيير كل يوم وفي كل جيل وبسرعة مذهله!!
والمشكلة هي أن الأهل نادرًا مايحاولون أن يتصرفوا على أساس رؤية الأمور من موقع الأبناء لا من مواقعهمهم، وهنا بالضبط ما أكدته الدراسات التي أظهرت أن أكثر من 80% من مشكلات المراهقة – في عالمنا العربي – كانت نتيجة مباشرة لمحاولة الوالدين تسييرأولادهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، وبالتالي يحجم الأبناء، وبخاصة في سنوات الشباب الأولى، عن الحوار مع أهلهم؛ لأنهم يعتقدون أن الآباء إما أنهم لا يهمهم أن يعرفوا مشكلاتهم، أو أنهم لا يستطيعون فهمها، أو أنهم – حتى إن فهموها – ليسوا على استعداد لتعديل مواقفهم لأنهم ليسوا على دراية بالجيل الحالي، هذا الجيل الذي تغير كل شيء عنده، من فن وغناء وموسيقى وملبس ومأكل…الخ.
وهكذا يلوذ البنون إلى “الضِّدِّية” (السباحة ضد تيار الأهل) بطريقة تؤلم الوالدين، ولكن دونما شعور منهم، وقد وصف شاب هذه الحالة بـ: [ الاغتراب بينه وبين والديه ]
فلماذا..؟ لماذا هذه “الضِّدية”؟ ولماذا حالة الاغتراب بين المراهق ووالديه؟
هذا السؤال إجابته تكمن في “محورية الأنا” التي يتميز بها المراهق؛ فالمراهق مدفوع – رغمًا عنه، وبحكم عوامل نفسية تعمل فيه في هذه المرحلة من نموه – إلى التركيز الشديد على ذاتيته الشخصية الناشئة التي تتحول إلى محور اهتمامه وتفكيره؛ حيث إنه يكتشف تمايزه وتفرده – وهو الذي كان بالأمس القريب جزءاً لا يتجزأ من بيئة عائلية في حالة اندماج معها – هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تطرأ عليه – دون وعي أو شعور منه – حالات من القلق والمزاجية وعدم الاستقرار و”أزمة هوية”.. (إنه مخاض ذلك المولود الجديد الذي وصفناه من قبل في العنوان الرئيسي: بالمولود الثائر.)
فانسلاخ المراهق – الذي نراه بشكل تمرد – عن مواقف وثوابت ورغبات الأسرة، ما هو إلا وسيلته لتأكيد وإثبات تفرّده وتمايزه، وهذا يستلزم بالطبع معارضة سلطة الأهل – سواء كانت صادرة بصورة حازمة أم بصورة هادئة؛ وذلك لأنه يعتبر أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو استخفاف لا يطاق بقدراته العقلية التي أصبحت موازية جوهريًّا لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية المتيقظة لديه، والتي تدفعه إلى تمحيص الأمور كافة؛ وفقًا لمقاييس المنطق عنده
إذن، هذا هو “المولود الثائر”؛ فما الحل؟